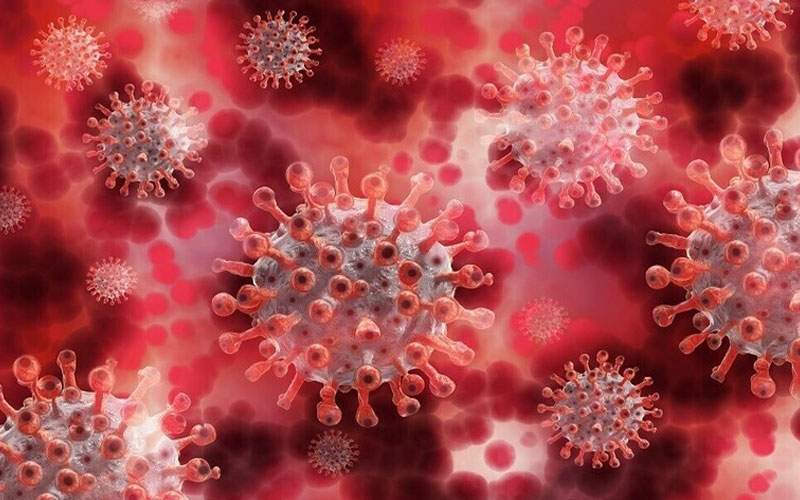أحمد فؤاد
فجأةً أصبح سؤال اللّحظة في العالم كلّه متى تتوقّف أزمة كورونا عن الإمساك بخناق العالم والضّغط المستمر على قلبه، في ظلّ حقيقة أنّه لا أحد يمتلك رفاهية الاستمرار بالجهود الحالية ذاتها من توفير نفقات هائلة للقطاع الصحّي وتحمل التّشغيل المتقطّع للقطاعات الإنتاجيّة، والقبول بكلفة الإغلاق للمناطق والمدن وعزلها.
ولأنّ لعبة الاقتصاد هي لعبة التّوازن والتّوفيق بين أهداف كبيرة، وأحيانًا مُتعارضة، وبين موارد قليلة لا تكفي لتحقيق كلّ شيء، فإنّه كان على دول العالم الانتقال للمرحلة الثانية، لوقف التّأثيرات المدمّرة للفيروس على الموازنات والضّغط المستمر على الإنتاج، والأهم لتمرير شعور جمعي بأنّ الأسوأ في أزمة كورونا قد مر، وبات وراءنا.
في وسط هذا الطّموح العالمي بعبور أزمة كورونا الهائلة، وكسر سيطرة الفيروس على تحديد مجالات الحركة وإمكانيّات النّمو، فإنّ الدول الغربية –عمومًا- تستند إلى عوامل موضوعية، تجعل من قرار اعتبار كورونا "مرضًا متوطّنًا" له أسانيده، من النّجاح في الوصول باللّقاحات الآمنة إلى أغلب السكان الراغبين في الحصول عليه، إلى قطاع صحي قوي ويستطيع استيعاب الأزمات المحتمَلة، وأضافت له المواجهة مع الفيروس طوال سنوات رصيدًا من الخبرة والثّقة، لتضع كلّ الظروف حكومات الدول الأوروبية على طريق الخلاص.
بينما يُعاني عالمنا العربي الأمرّين من الفيروس القاتل والحكومات المهتزّة الضّعيفة، من فشل في استغلال إلغاء بعض شركات الأدوية لحقوق ملكيّتها الفكريّة على اللّقاحات لتدشين بعض مصانع الأدوية وخطوط إنتاجها، إلى التلكّؤ في توفير لقاحات آمنة مثل بقيّة دول العالم، وأخيرًا الفشل في تعديل أوضاع القطاع الصحي، والذي فشل في كلّ الدول العربية معظم الوقت في مواجهة ضغوط تفشي الجائحة، بفعل إهمال طويل واعتماد متزايد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذا هو بيت الداء العضال.
السير في –وإتّباع- الوصفة الجاهزة لمؤسّسات التّمويل الدولية بخروج الدولة من قطاعات النّشاط الاقتصادي كافّة، والتّخلي عن تقديم الخدمات إلى المواطن العربي، كانت مفتاح الفشل وأوّل طريق البؤس تحت ظلال أزمة كورونا، ويُضاف إليه خيبة معتادة في التّعامل مع المواقف الطارئة، وعجز كامل عن الحركة حين تتعقّد الظّروف وتغيب الرؤية الصحيحة لمكمن الخطر.
بهذه الظروف البائسة، قَبلت الحكومات العربية كلّ ما كان يعرض عليها من لقاحات، بغية معالجة فشلها في التّعاقد المبكّر على اللّقاح، ثمّ وهو الأمر الأهم لكي لا تتورّط في دفع مئات الملايين من الدولارات، كون الشّحنات التي تتحصّل عليها أغلب الدول العربية مجّانية تمامًا، عبر آلية "كوفاكس" أو مسرع توزيع اللّقاحات العالمي، والذي يوفّر للدّول متوسّطة وقليلة الدخل اللقاحات.
على سبيل المثال لا الحصر، فإنّ دولة الدنمرك قرّرت تقديم 429 ألف جرعة من لقاح موديرنا مخصّصة للأطفال إلى وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، وتزامنت مع حملة تلميع سياسية معتادة للمساعدة الدَنمركية السخيّة الموجّهة إلى الأطفال والدولة اللبنانية، ثمّ فجأة تخرج الأنباء بأنّ دولة فنلندا ترفض منح الأطفال والشباب اللّقاح الدَنمركي، كما أنّ السويد هي الأخرى رفضت منح الأطفال والشباب (من 5 إلى 18 عامًا) الجرعة الثانية من اللّقاح ذاته، عقب الكشف عن تأثيرات مدمّرة للدواء على الجهاز التنفّسي وعضلة القلب!
لكن ما لا يصلح لأطفال الغرب، قد يكون صالحًا للتجربة هنا على الأطفال العرب، وكأنّنا أرخص سعرًا من السيد الأبيض الأوروبي.
ويظلّ حال الاقتصاد المُعولم قضية كلّ الأيام، الأزمة الأولى التي تستحقّ الفحص والدّرس الجيّدين، وبعدها فإنّ ما يضرب العالم كلّه من تداعيات –لا تزال مستمرّة- لتفشّي جائحة كورونا، والألم والنّزيف النّاتج عنها، انعكاس لعمليّة الممارسة الفعلية لهذا الوحش الذي ينخر عظام الشعوب ويفترس ثروات الدول، لصالح الغرب، ثمّ يذبحنا على عتبة التّجارب البيضاء.
بالتأكيد، وبدون أيّة تحليلات أو تشاؤم، فإنّ ما يجري في العالم الآن هو السّبب المباشر لسيطرة الرأسمالية، وليس مجرّد أزمة أو وجه مؤقّت لهذه الرأسمالية الجشعة، وكلّ التداعيّات الاقتصادية مقرّرة سلفًا على البلدان الأصغر والأضعف، وكأنّها خطوة واحدة وسط سياق ممتدّ ومستمرّ، جرى قبلها واستمرّ بعدها، يستنزف ويعصر ويجفّف كلّ إمكانيّات الخروج من حالة الهشاشة التي تغرق بها دول الأطراف في عالمنا، ودون أن تمتلك الدول العربية الإرادة ثمّ الرؤية الوطنيّة القادرة، فإنّ السّير في الدائرة المميتة مستمرّ وطويل.