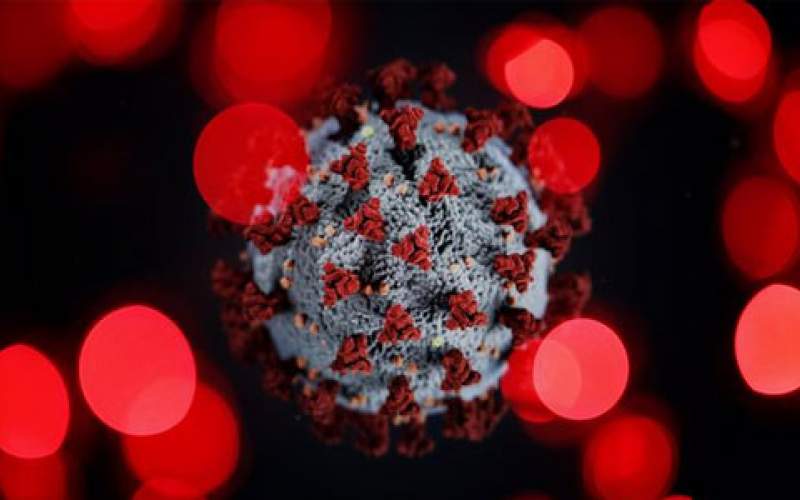(محمد أ. الحسيني/ كورونا نيوز)
منذ أن حطّ فيروس كورونا (covid-19) بثقله على العالم قبل عام ونيّف من اليوم، ودرجة الغليان الإقتصادي والإجتماعي آخذة بالتصاعد، لتشكّل أزمة هاجس وجودي يعاني منها كل فرد أصيب بالفيروس، أو قارب الإصابة بها أو شفي منها، ومن لاقى حتفه يخلّف حالة بؤس وحزن ممزوجة بهلع عارم من مقاربيه مخافة أن يكون أحدهم الضحيّة المقبلة لهذا الوباء الغامض، فكيف به وقد سجّل خلال أقل من عام تحوّلات بنيوية، ليضاعف الخطر ويزيد نسبة الهلع ليصل إلى ما يشبه الإرتياب المرضي الذي يسمّم العقل والتفكير قبل أن يصيب الجسد بعوارض الوهن وضعف المناعة، فيجعل من نفسه فريسة سهلة للوباء.
قيل الكثير من فرضيات المؤامرة حول فيروس كورونا، وانتشر العديد من الأفلام والمقابلات والتحقيقات المسجّلة القديمة والجديدة، التي تحدثت عن كونه فيروساً مهجّناً من صنيعة المختبرات العلمية، وليس وليد مزيج من فيروسات متأتية من القرود أو الخنازير، وأنّه واجهة لمخطّط عالمي – ماسوني جهنّمي يهدف إلى السيطرة على البشرية انسياقاً مع اتجاهات العولمة الإقتصادية، وما تفرزه من مظاهر نمطية ثقافية وسلوكية تصل إلى حد توحيد النموذج في المأكل والمشرب والملبس وغيرها، وصولاً إلى صناعة نموذج الإنسان الجديد المقولب في إطارات محدّدة بالصفات والعناصر الحيوية الذاتية، أما الشركات الكبرى المصنّعة للدواء فتستغلّ الوباء لتحقّق الأرباح الخيالية من بيع اللقاح، وهذه الخطوة في الإستغلال التجاري لحياة الناس لا تنفصل في فلسفتها عن المسار التاريخي لسيرورة الشعوب منذ بَدء الخليقة، وستستمر إلى حين فنائها، فكلّ الحروب والإحتلالات كانت ولا تزال تندلع للسيطرة وتملّك ثروات الماء والطاقة والتحكّم بالممرّات البحرية واستغلال الأرض والناس تحت مبرّر الصراع من أجل البقاء.
وسواء صحّت هذه المقولات أم أنّها مجرد إسقاطات تشبه ما سبقها من "نبوءات" عن مستقبل متحوّل للعالم، إلّا أنّ الحقيقة الراهنة تفيد بأنّ هذا الفيروس لم يعد مجرّد عارض صحي يشبه ما سبقه من فيروسات ينتشر في مرحلة ما ثمّ يختفي لوحده، أو بنتيجة وجود لقاح وعلاج؛ ولم تعد الكمّامة واقية من خطر التلوث كما في بكين وطوكيو وغيرها من العواصم الموبوءة بالتلوّث الصناعي، فكل شيء وكل فرد الآن أصبح ملوّثاً ويحمل خطر انتقال المرض الفتّاك، ولم تعد مداخن المصانع الكبرى التي تهدّد باتساع فتحة الأوزون وترفع درجة الإحتباس الحراري هي المشكلة، بل أصبحت المشكلة على الأرض بدل أن تكون في الفضاء، وتحوّل كل فرد إلى مصدر تلوّث مميت.
أصبح فيروس كورونا المستجدّ والمتحوّر والمتحوّل والمتجدّد محفّزاً لتحوّل البشرية نحو نمط جديد من الحياة الإجتماعية، ولا نتحدّث هنا عن بيئة خاصة بعينها، بل في كل البيئات التي أصابها الفيروس، وإذا ما استثنينا أولئك الذين يكابرون في إنكار وجود هذا الوباء استناداً إلى موروثات تربوية واعتقادية ملتبسة، نرى أنّ غالبية البشر في هذا العالم بدأ يركن إلى نسق جديد في العلاقات الفردية، سواء في البيئات المنزلية بين أفراد الأسرة الواحدة والأقارب، أو في أماكن العمل ومراكز التسوّق وغيرها من المساحات التي تشهد تجمّعات طبيعية للناس، لا بل حتى على الطرقات والشوارع وفي حافلات النقل العامة والخاصة، وهذا النسق ينزع إلى الفردانية في السلوك، وكل فرد آخر بات بمثابة خطر محتمل يحمل معه فيروس الموت، حتى لو لم تظهر عليه عوارض الوباء القاتمة.
إذاً ما هو هذا الوباء في الهوية النفسية والإجتماعية؟! وما هي تأثيراته غير الصحيّة؟! وإلى أي حدّ يمكن وضع سيناريوهات سوداء حول تداعيات هذا الطاعون المميت على مستوى البِنية الإنسانية؟! وحتى نتلمّس الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يمكن لنا أن نستشرف واقعاً غير خيالي لا بدّ أنّنا قادمون إليه، فلنفترض أنّ الشركات الصناعية والتجارية الكبرى – التي أصبحت تتحكّم بالحكومات والأنظمة العالمية – نجحت في اجتراح لقاح يقي الناس من الإصابة بهذا الفيروس، فإنّ إتمام عملية التوزيع على أكثر من سبعة مليارات بشري لن تتمّ قبل بضع سنوات اعتباراً من اليوم، فكم سيحصد هذا الوباء من ضحايا حتى ذلك الحين؟ أضف إلى ذلك أنّ غالبية الظواهر اليوم تجزم بأنّ أي لقاح - شأنه شأن معظم الأدوية العلاجية - سيترك حكماً أعراضاً جانبية على الأفراد، ومنهم من يستطيع التغلّب على هذه الأعراض ومنهم من تودي به إلى حتفه، فكم من الناس قادرون على تحمّل هذه الأعراض وينجون بأنفسهم؟!
وتبعاً لهذا السيناريو، فمن لم يتلقّ هذا اللّقاح سيبقى في بيئته ومجتمعه فرداً منبوذاً جالباً للخوف والهلع، حتى لو لم يصب بالفيروس أو لم تظهر عليه أعراض المرض، ومن المرجّح جداً في هذه الحالة أن يصبح التلقيح إلزامياً لكل الناس للحيلولة دون الوصول إلى حالة من الفرز العنصري بين البشر، ليتحوّل هذا الفرز تالياً إلى طبقية صحية – إجتماعية من نوع جديد، وارتباطاً بهذا المُعطى لا بدّ أن يتمّ تقسيم الناس إلى فئات وفق أولويات مختلفة للمباشرة بتلقيحهم بالدرجة الأولى، وسيكون الفقراء أو الأدنى أهمية في التصنيف الإنتاجي البشري، هم الأدنى حظاً في الحصول على اللقاح الإلزامي، وهكذا نصبح أمام تجدّد ظاهرة جديدة من الإستعباد والعبودية، ولا يمنع من أن يتمّ توزيع بطاقات طبيّة خاصة تفيد أنّ حاملها قد "تحصّن" باللقاح، وتتحوّل هذه البطاقة لاحقاً إلى جواز عبور أو إفادة تمنح الفرد الصلاحية للتقدّم إلى وظيفة ما، أو التقدّم للزواج، أو الدخول إلى أمكنة التجمّعات البشرية، أو أي شكل من أشكال الحياة اليومية العامّة.
يتوقّع بعض الإعلاميين والأطباء ومختصون في بحوث التاريخ المجتمع أنّ العالم مُقبل إلى مرحلة تصفية، بحيث يموت ما يُقارب نصف سكان الأرض بسبب فيروس كورونا أو غيره من الأوبئة المحتملة المنتظرة، ولن يبقى على وجه البسيطة إلا القوي أو بتعبير آخر "نموذج الإنسان الكامل الذي يستحق الحياة ويؤسس لنسل خالٍ من الأمراض ومواطن الضعف"، وهذا المنحى في الإبادة البشرية لم تنجح الحروب العالمية في تحقيقه، ولا موجات الفيروسات السابقة التي حصدت مئات الآلاف من الناس في أكثر من قارة.. إنّ هذه المقولة تعدّ أخطر جوانب السيناريوهات السوداء التي تتفيأ ظلال فيروس كورونا، وإذا ما تحقّقت فسنكون حتماً أمام "نهاية التاريخ" على حد تعبير منظّري الرأسمالية وروّاد الجدلية الماديّة، وهو ما سيفتح جبهة شاملة من الصراع مع من ينكرون هذه النظرية.
إنّها الفوضى الشاملة، والغلبة للأقوى.